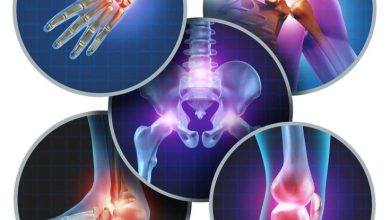قراءة قانونية-سياسية في ضوء تصويت 10 مايو 2024 والتحولات الأوروبية والإقليمية
مقدمة:
شهدت القضية الفلسطينية منذ عام 1948 تداخلاً بين أبعاد تاريخية وسياسية وقانونية وإنسانية. بعد النكبة تشكّلت هويات لاجئة وسياسات متعدِّدة الأطراف وحروب متعاقبة؛ وعلى الصعيد المؤسساتي، تمتع الفلسطينيون بتمثيل متدرّج داخل منظومة الأمم المتحدة، حتى منحت الجمعية العامة وضع «دولة مراقب غير عضو» في 2012، بينما ظلّ الطريق نحو العضوية الكاملة رهينًا بموقف مجلس الأمن ونزعات القوى الكبرى.
التطورات الأمنية والقانونية خلال العقدين الأخيرين (بما في ذلك خطوات المحاكم الدولية والتحركات البرلمانية والدبلوماسية) وضعت مسألة الاعتراف الدولي في واجهة السياسات الخارجية لبعض العواصم، وتبلورت ذروة مؤقتة لهذا المسار في قرار الجمعية العامة في 10 مايو 2024 الذي منح فلسطين حقوقًا أوسع داخل الجمعية وعزّز حججها نحو عضوية كاملة .
أولًا: الإطار القانوني الدولي للعضوية والاعتراف — بين ميثاق الأمم المتحدة والعدالة الدولية
الاعتراف بدولة في القانون الدولي يرتكز على مزيج من معايير الموضوع (الأراضي والشعب والحكومة والقدرة على الدخول في علاقات دولية) وبروتوكولات عضوية الأمم المتحدة (المادة 4 من الميثاق).
لكن الأهمية العملية للاعتراف لا تقف عند تعريف الشكل بل تمتد إلى تبعاته: الحقوق داخل الهيئات الدولية، القدرة على رفع دعاوى أو قبول ولايات محاكم دولية، ووضعية التمثيل الدبلوماسي والاتفاقات الثنائية.
اقرأ أيضًا: وفد برلماني تركي يزور رفح ويشيد بدور مصر تجاه القضية الفلسطينية
في هذا السياق، أصدرت محاكم دولية ودوائر فنية قرارات وطلبات تنفيذ (مثل آراء ومحاكمات ماضية) يظهر أنها بمقدورها تكريس عناصر من شرعية فلسطينية دولية أو على الأقل تقييد سلوك السلطة القائمة بالاحتلال .
على سبيل المثال، أصدرت محكمة العدل الدولية (ICJ) أوامر وإجراءات مستمرة تتعلّق بملفات مرتبطة بالوضع في الأراضي الفلسطينية (طلبات تحفظية وأوامر في 2024-2025) والتي أوجدت إطارًا قضائيًا ضاغطًا على سلوك الدول والجهات الفاعلة. كما أن مآلات الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية (ICC) تزيد من البعد القانوني الخاضع للاعتراف الرسمي، لأن وضعية دولة فلسطين تُسهِم في قدرة مؤسسات قضائية دولية على التعامل مع قضايا الجرائم الدولية في الإقليم.
هذه المسارات القانونية على نحو متزايد تُحوّل الاعتراف من مفردة رمزية إلى مدخل عملي لآليات مساءلة وشرعية سياسية.
ثانيًا: الوقائع والبيانات — تصويت الجمعية العامة والخرائط الواقعية للاعتراف
في 10 مايو 2024 اعتمدت الجمعية العامة خلال دورتها الطارئة القرار A/RES/ES-10/23 الذي «يحدد أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة» ويمنحها حقوقًا أوسع بصفتها «دولة مراقب» داخل الجمعية؛ القرار مرّ بتسجيل تصويت: 143 صوتًا لصالحه، 9 ضد، و25 امتناعًا — وهو انعكاس رقمي لتمايز المواقف الدولية وامتداد الدعم الشعبي والدبلوماسي لفكرة الاعتراف، مع الإشارة إلى أن المسار نحو العضوية الكاملة يظلّ مقيدًا بضرورة توصية مجلس الأمن (التي تتأثر بفيتو الدول الدائمة العضوية). هذه الأرقام والنتيجة الرسمية تشكل نقطة مرجعية أساسية لفهم دينامية الاعتراف الدولي المعاصرة.
تلا هذا التصويت سلسلة من الاعترافات الوطنية، على رأسها إعلانات حكومات إسبانيا وإيرلندا والنرويج وسلوفينيا التي أعلنت خلال أيار/مايو – يونيو 2024 اعترافها بالدولة الفلسطينية؛ هذه الإعلانات بمصادر حكومية رسمية تؤكّد دخول أوروبا في مرحلة تكيّف دبلوماسي جديدة، حيث صارت بعض عواصم القارة تتحرّك أحاديًا أو بالتنسيق مع مجموعات صغيرة احتجاجًا على فشل مسارات التسوية التقليدية. (انظر بيانات حكومات: إسبانيا، إيرلندا، النرويج، سلوفينيا ).
وفي المقابل، البرلمان الأوروبي:
• في 11 سبتمبر 2025، عبّر البرلمان الأوروبي عن دعوة غير ملزمة للدول الأعضاء بالنظر في الاعتراف بفلسطين، لكنها لم تكن تصويتًا على عضوية أو صفة رسمية داخل الأمم المتحدة، بل توجيهًا سياسيًا داخليًا.
حيث صوّت المجال بـ 305 تأييدًا، 151 معارضة، و122 امتناعًا .
اقرأ أيضًا: السيسي يؤكد دعم مصر للمبادرة السعودية-الفرنسية لتسوية القضية الفلسطينية
ملاحظة كمية: تصريحات حكومات هذه الدول تشير إلى أن عدد الدول المعترفة وصل قرب حدود 147 دولة بعد هذه الجولة من الاعترافات، وهو مؤشر مهم على اتساع قاعدة الاعترافات لكنه لا يعني بالضرورة تغيرًا فوريًا في السيادة الميدانية أو الاختصاصات الأمنية على الأرض .
ثالثًا: التداعيات الإقليمية ودور الوساطة المصرية
تبرز وساطة دول الجوار، وعلى رأسها مصر؛حيث تاريخيًا تمتلك القاهرة أدوات نفوذ عملية: إدارة معبر رفح، علاقات أمنية مع الأطراف الفلسطينية، وقدرة على استضافة حوارات فصائلية، فضلاً عن امتلاكها ثقلًا دبلوماسيًا مع قوى إقليمية وغربية.
تصريحات رئاسية ومواقف رسمية مصرية أكدت تواصل القاهرة مع شركاء دوليين لوقف التصعيد وتسهيل دخول المساعدات، مع رفض واضح لأي تغييرات أمنية على حدودها أو قبول بوجود قوة عسكرية أجنبية دائمة على معبر رفح. هذا الدور المركزي يجعل من القاهرة شريكًا أساسًا في أي خارطة عملية لتحويل الاعتراف السياسي إلى تدابير على الأرض (بما في ذلك ترتيبات لمعابر آمنة، دعم مؤسسات إدارة الحدود، وبرامج إعادة إعمار منسقة دوليًا ).
إقليميًا، عبّرت منظمات مثل منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية عن دعم للمبادرات الدولية التي تؤدي إلى حماية حقوق الفلسطينيين وتعزيز الدولة، ما يوفّر غطاءً سياسياً ودبلوماسياً أوسع للاعترافات ويحفّز دولًا إضافية على التحرك .
رابعًا: الموقف الأوروبي — بين المؤسسية والعضوية الوطنية والتحوّل السياسي
المشهد الأوروبي تجلّى على مستويين متداخلين: مستوى مؤسسات الاتحاد (الذي يحتاج إجماعًا صعبًا في قرارات خارجية حاسمة) ومستوى الدول الوطنية التي تتخذ خطوات أحادية للضغط على الواقع. على مستوى المؤسسات، تبنّى المجلس الأوروبي ولجان السياسة الخارجية مواقف تندّد بالانتهاكات وتحضّ على احترام القانون الدولي، وفي الوقت نفسه صيغَت توصيات ومشروعات تدعم بناء مؤسسات فلسطينية وتعزيز الاستقرار الإنساني، مع حرص على إبقاء الباب مفتوحًا للعملية السياسية.
على مستوى الدول، تتباين الدوافع: دول رائدة (إسبانيا، إيرلندا، النرويج، سلوفينيا) رأت في الاعتراف طريقة للحفاظ على حل الدولتين ومنع تحوّل الوضع إلى نظام واحد يهدّد الأمن الإقليمي؛ بينما دول أخرى (ألمانيا، إيطاليا وغيرها) بقيت مترددة، مرتبطة بحساسية أمنية وتاريخية وارتباطات استراتيجية.
اقرأ أيضًا: السيسي وولي العهد الأردني يبحثان تطورات القضية الفلسطينية
هذا التباين الأوروبي يجعل من الاعتراف ظاهرة سياسية قابلة للتصعيد الرمزي لكنه مرهونة بتحويله لسياسات تنفيذية (ربط المساعدات، مراجعة الاتفاقات الاقتصادية مع إسرائيل، آليات مراقبة الاستيطان) لتحصيل أثر فعلي. على مستوى البرلمان الأوروبي، برزت دعوات ومشروعات قرارات تدعم الاعتراف كأداة سياسية متزامنة مع شروط تنفيذية.
الخاتمة
إن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين ليس مجرد محطة رمزية في مسار طويل من النضال الدبلوماسي، بل هو اختبار حقيقي لقدرة المجتمع الدولي على ترجمة الشرعية إلى واقع. فإذا أرادت أوروبا أن تثبت صدقية خطابها الحقوقي وأن تحافظ على وزنها كفاعل استراتيجي في الشرق الأوسط، فإن المطلوب منها الانتقال من مستوى “الاعتراف السياسي” إلى مستوى “التنفيذ العملي”، عبر توفير ضمانات قانونية، دعم اقتصادي مستدام، وترتيبات أمنية تحمي الفلسطينيين وتعيد ضبط العلاقة مع الأطراف الأخرى.
كما أن الدور العربي، وعلى رأسه الوساطة المصرية، يظل حجر الزاوية لأي تسوية عادلة وشاملة. إن اللحظة الراهنة تفرض مقاربة مؤسسية متكاملة تضع الأساس لدولة فلسطينية قابلة للحياة، كجزء من نظام إقليمي أكثر استقرارًا وتوازنًا.
المقال كُتب بواسطة: نورهان محمد يوسف، باحث ماجستير في العلوم السياسية والتخطيط الإستراتيجي.